من أي عتمة في الوعي أبحرت سفائنه؟ وتحت لثام أي ليل رسا في مراسينا؟ ومن أي غبشة في الفكر تسلل، خلسة، حتى بات بين أضلاعنا في الصدور؟ وكيف حلّ بيننا كأنه القدر. كأنما، هو، الريح لا تبقي ولا تذر، حيث تطأ قدمه الأرض يندلع الحريق، وتنعق الغربان من فوق الخرائب؟
البكباشي جمال عبد الناصر حسين، المولود في الإسكندرية عام 1918، والذي أصبح بعد خمسة وثلاثين عاما من مولده، رئيسا لمصر، وزعيما للـ«أمة» العربية. وحقق لبلده وأمته مهرجانا من الخسارات لم «ينجزها» أحد قبله، أو بعده.
خسر الحرب وخسر السلام. وخسرت بلاده حرب السويس، وحرب اليمن، والوحدة مع سوريا، وحرب حزيران (النكسة)، مثلما خسرت الديمقراطية، والأحزاب، والصحافة، والمجتمع المدني، والتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والحريات، وحقوق الإنسان.
خسر وخسّر العرب. فخسر الأردن الضفة الغربية والقدس. وخسرت سوريا الجولان. وخسر لبنان جنوبه بعد أن خسر سيادته. أما الشعب الفلسطيني فقد خسر قضيته، ولم يقطف من شجرة الناصرية سوى المزيد من الضياع. وخسر العرب، كل العرب، فرص التنمية، وضاع الوقت والجهد والمال بين قتال، وسجال، وقيل وقال.
فكيف تحولت الخسارة إلى ربح؟ والهزائم إلى انتصارات؟ والمهزوم إلى بطل وطني وقومي؟ وكيف صدّقت كل هذه الملايين من الناس العرب حكاية الناصرية؟
اسأل عن حق، انشد الحقيقة عمن يكون عبد الناصر ليتولى أمر مصر؟ هل (هو) الزعيم الذي عرفناه، وتبعناه، واحتضنا صورته، وحفظنا خطبته، وقلدنا لغته، وأنشدنا أغنيته، وحاربنا تحت رايته، وحين استقال أضعناه، فناديناه. وعندما هوى بكيناه وشبهناه بآخر الانبياء؟ أم انه (شيء) آخر؟
أي بساط سحري حمل جمال عبد الناصر حسين، وهو لم يتجاوز رتبة «مقدم» ولم يبلغ الخامسة والثلاثين من العمر، ولا يملك أي موهبة لافتة، لينصبه حاكما لدولة كبيرة اسمها «مصر» يخترقها «نيل» خالد، وتطل على بحرين «أحمر» و«أبيض».
فكيف يجري في مصر العظيمة، تلك، سيناريو صغير لانقلاب صغير لم يستغرق سوى ليلة صغيرة واحدة، بقيادة ضباط صغار، يقوم أحدهم «عبد الحكيم عامر» بمصارحة ضابط كبير «محمد نجيب»، بأمر الانقلاب قبل حدوثه بأربع ليال، فينصاع الضابط الكبير لأمر الشاب الصغير.
هل يحدث مثل ذلك في الواقع المعيش؟ هل يحدث ذلك في جمهوريات الموز، أو اللوز، أو الكستناء؟ هل يحدث ذلك في الدول الافريقية التي يتم تبديل الحاكم فيها مع تبديل التوقيت الصيفي الى شتوي؟ هل يحدث مثل ذلك في ثقافات غير عربية؟ وهل يقبل صنّاع السينما بمثل هذا السيناريو؟ أم تراهم يحسبون حساب عقل المتفرج؟ في الوقت الذي لا أحد يحسب حسابا للعقل العربي؟!
هل تساءل العرب عن العلاقات الاجتماعية، والحنكة السياسية، والذهنية الاقتصادية، والمهارات الشخصية، والخبرة العسكرية، والدرجة العلمية، والملكات الفردية. والقدرات العقلية (المتميزة)، التي مكنت عبد الناصر ليتحكم بمصير ملايين المصريين؟
فهل الذي عرفناه عن قصة (ثورة يوليو) حقيقة ثابتة؟ أم انه لغز وسيناريو من خيال؟
زعيم وزعيم
لو عنّ لأحد أن يقارن بين «جمال عبد الناصر» وآخرين، مثل «الاقتصادي طلعت حرب، أو الممثل يوسف وهبي، أو الاديب طه حسين، أو السياسي سعد زغلول، أو نحوهم» لقال قائل بعدم جواز المقارنة لاختلاف الادوار. لكن ماذا لو تفحصنا شخصيتي «عبد الناصر» و«أنور السادات»، فكلاهما عضو في الضباط الاحرار، وكلاهما تولى حكم مصر في سنوات متقاربة.
ان أي مقارنة بين شخصية عبد الناصر وشخصية السادات ستكون، لاشك، لصالح الاخير. فالسادات يمتلك (كريزما) لم تتوافر لعبد الناصر، «لولا ماكينة الدعاية الناصرية». فملامح السادات، سمته، نبرة صوته، طريقته بالكلام «اللجلجة»، حركة اليد ولغة الجسد، «عفويته»، كل ذلك يدل على (مصريته) من ناحية، ومن ناحية اخرى يدل على تمتعه بشخصية (استثنائية) بصرف النظر عن حكمنا السياسي عليه.
ان الوثائق والحقائق تؤكد أن السادات، بعكس عبد الناصر، كان شخصا معروفا قبل عام 1952 حين اشتغل بالحياة السياسية «السرية»، والقي القبض عليه بتهمة تهريب عزيز المصري، و سجن بتهمة الاتصال بالقوات النازية الالمانية، كما سجن بتهمة اغتيال أمين عثمان، اضافة الى عمله بالصحافة وفصله من الجيش وعودته مرة اخرى.
صورة افتراضية
بعدما تقدم، نسأل الحقيقة. أين جمال عبد الناصر خارج اطار الاعلام الناصري الرسمي، وقتذاك؟
الجميع يتذكر اللقاءات المباشرة مع الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية التي كان يعقدها الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، الذي كثيرا ما يتعرض الى اسئلة صريحة، فيرد عليها بأجوبة تعكس شخصية «استثنائية» تليق بمنصبه «الاستثنائي» كرئيس لمصر.
فهل يتذكر مصري، أو عربي واحد، انه شاهد أو سمع مؤتمرا صحفيا «مباشرا» لجمال عبد الناصر، يرد فيه على أسئلة الصحفيين؟ ولماذا لم تسجل اجهزة التلفزة الغربية لقاء تلفزيونيا مباشرا مع عبد الناصر؟ وهي التي صورت وسجلت رواد الفضاء في اعالي السماء، وغرائب الاسماك في اعماق البحار؟ ولماذا لم يستضفه أحمد سعيد في اذاعته العتيدة (صوت العرب)؟
فمن يكون عبد الناصر؟ وهل (هو) هو؟ أم ان الذي كنا نراه شخص آخر بدلت حقيقته عمليات مونتاج ومكساج ومكياج، وأجهزة اعلام رسمي متقدم فاقت عقل تلك المرحلة. فظهر «ناصر كلنا بنحبك ناصر» على مسرح الطرب في صوت عبد الحليم حافظ، اكثر من ظهوره على مسرح الحقيقة.
ذلك أن لحظة الكشف العربي تتجلى بالمعازف لا بالمعارف. والناس تبلغ ذروة المعرفة بواسطة المغنى لا بالمعنى.
نعم، لو كانت مصر في اليوم المؤرخ بـ23 يوليو 1952، تملك سيادتها واستقلالها، لقلنا ان نجاح عبد الناصر تم بسبب (الغفلة) العربية المعروفة. لكن ذلك لم يكن، فمصر وقت قيام (الثورة) كانت واقعة تحت (الاحتلال) البريطاني الذي استمر حتى عام 1954، أي بعد نجاح انقلاب جمال عبد الناصر حسين بعامين اثنين. هنا يجن في العقل سؤال: كيف تكون ثورة ضد الملك المصري، والبلاد تحت الوصاية البريطانية؟! وكيف يتمكن شبان صغار من تنفيذ انقلاب عسكري في بلد يحكمه ملك، وحكومة، وشرطة، وجيش، وجحافل دولة عظمى بكل ما تملك من قدرات، وأجهزة وأسلحة، واستخبارات، ورجال خفية وعيون؟
أما السؤال الأجنّ، فيتلخص بـ: هل جرت العادة (الثورية) ان يخبر الانقلابيون الصحافة عن ساعة الصفر وموعد الانقلاب؟ كما فعل «الضباط الاحرار»، الذين أخبروا محمد حسنين هيكل، الصحفي في جريدة «اخبار اليوم» بموعد الانقلاب، فكان بصحبتهم لحظة الانقلاب في مبنى رئاسة الاركان؟ وكيف تستقيم السرّية مع التغطية الصحفية؟ أم ان الذي جرى لم يعد كونه (سهرة) انقلابية، لا علاقة لها بالسياسة؟
أخلص الى القول ان «ثورة يوليو» فنتازيا سياسية اشبه بروايات الف ليلة وليلة، وأقرب للخيال منها الى الحقيقة. أما التي أغرب منها وأعجب، فالشعوب العربية التي شاركت، طواعية، بماراثون الجري وراء السراب، ولا تزال تجري وتجري وتجري، وكل العالمين يسمعون لهاثها (لهاثنا).
لست اكتب بغرض التجريح بشخص الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، فاحترام الناس أحياء او أمواتا، مسؤولية مهنية احرص عليها. بيد أني اكتب بغرض الانضمام الى هؤلاء المطالبين بإعادة كتابة التاريخ السياسي العربي. المنادين باستعادة الوعي العربي المسحور، وانتشاله من تحت انقاض الثوابت.
أكتب من أجل وقف دوران دولاب (الوهم) هذا. ففي عوالمنا العربية المريضة، المتخلفة، لا تزال الاجيال الطالعة الناشئة، تؤمن بـ«الناصرية والصدامية والبنلادنية»، وذلك أمر جلل لا أحسبه ينطوي على خير لهذه الشعوب التي خاصمت نفسها، وخاصمت الآخرين. فتعلقت بثوابت هي أقرب لخيوط مغزولة من دخان.
صلاح الساير

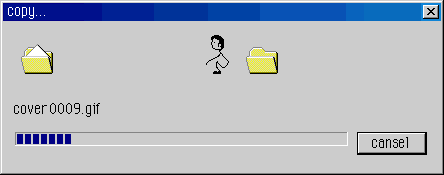
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق